المربعات الحمراء
مقدمة الراوي:
جسر نحو السماء
كلّما تقدمتَ أكثر في محلة خاكفرج بمدينة قم، أصبحت الأزقّة أطول وأضيق وأكثر التواءً. انتشرت البيوت بطريقة عشوائية كالأعشاب واتكأت على بعضها البعض. شَقَّ القيرُ الذي أصبح رمادياً طريقه وسط هذه الأزقّة كثيرة الانحناءات. في تلك الليلة كنّا مدعوّون لتناول العشاء في منزل الخالة أشرف. أقمنا صلاة المغرب في المسجد ثم ذهبنا إلى منزل الخالة مرتدين أفضل ملابسنا.
كان الزقاق مزدحماً، وكان الرجال يسيرون بملابس البيت باتجاه منزل الخالة:
- السيد (الخميني) حلّ ضيفاً في منزل الشيخ ميانجي.
هذا ما قاله أحد الرجال لأبي ثم حثّ الخطى. هذه الكلمات جعلت أبي يحثّ الخُطى هو الآخر، وأنا أيضا فعلتُ ذلك. أرادت أُختي "مهري" أن تأتي معي لكنّ أُمّي أمسكت بيدها. عبرنا منزل الخالة "أشرف" ونحن نسير مع الجموع. كان الرجال قد تجمعوا عند درجتي سلّم في نهاية الشارع، وهم يمدّون رقابهم للنظر. الحسرة بادية عليهم. نظرت إلى بداية الشارع فلم أر سوى سيارة تشق الظلام بمصابيحها. كان البعض ممن شاهدوا السيد يخبرون الآخرين بما شاهدوه والعَبْرة تكاد أن تخنقهم. جفّف أبي الدموع التي تجمّعت في زاوية عينه بيده، وتنفس بعمق والحسرة بادية عليه. شققت طريقي بين الناس لأدخل المنزل الذي كان بابه مفتوحاً. منزل آية الله أحمدي ميانجي الذي حل السيد ضيفاً في منزله.
لا أتذكر اليوم والشهر ولكن الأمر حصل في عام 1980 وكنت في الثانية عشرة من عمري. عندها لم نكن أنا وجعفر قد أصبحنا أصدقاء بعد ولم أكن أعرف آية الله أحمدي ميانجي. خفضتُ رأسي ودخلت إلى المنزل من دون أن يدعوني أحد للدخول. كان الجميع يتكلمون عن السيد الخميني الذي كان قبل دقائق ضيفاً في هذا المنزل. نظرتُ إلى جميع زوايا الغرفة الصغيرة فتأكدتُ من أنني قد تأخرت في الوصول، فقد ذهب السيد. كان مكانه خالياً على الفراش المتّكئ على الحائط وأمامه طبقٌ بقي فيه نصف تفاحة.
في تلك الليلة وجدتُ نفسي بالصدفة في منزل رجل الدين في محلتنا، آية الله السيد ميانجي. جلست في منزله من دون أن يدعوني أحد، وتناولتُ نصف التفاحة المتبقي في الصحن. لم تكن مساحة المنزل تتجاوز الستين متراً، أما الصالة الخارجية، أي غرفة الضيوف، فقد كانت بسيطة جداً وتختلف كثيراً عن غرفة الضيوف في منزلنا التي كانت تحتوي على أثاث.
ذكرى تلك الليلة ظلّت عالقة في ذاكرتي جيداً. وأصبحتْ أبرز ذكريات طفولتي. حاليّاً كلّما فكّرتُ بطفولتي وشغبي خلال تلك الأيام، أتذكر تلك الليلة أولاً. ذكرى ذلك المنزل وصاحبه العطوف. الرجل صاحب الأخلاق الحسنة الذي أصبحتُ مديناً له. العالم الذي قضى أيام شبابه وأيام دراسته في هذا الحي. وبعد ذلك بقي في نفس المكان بدلاً من أن ينتقل إلى الأحياء الراقية. كان يُردّد: "أنا أصبحتُ عالماً وأنا بين هؤلاء الناس". الرجل الذي قضيتُ أيامي الذهبية إلى جانب أهل بيته. الطعام الحلال الذي وفّره لي أبي من ناحية، والطعام النوراني الذي تناولته عند أهل هذا البيت بصورة خاصة عند آية الله ميانجي وابنه الأصغر جعفر من ناحية اُخرى. مهما كتبتُ أو قلتُ فإني لن أستطيع أن أوفي آية الله ميانجي حقّه. العالم الذي سبق عملُه عِلْمَه. العالم الذي جسد حديث: "العلماء باقون ما بقي الدهر ". كان الأسمى والأكثر اخلاصاً. لم يكن يعتبر نفسه أعلى من الآخرين مكانة. لا أعلى من مراهق مثلي أنا، ولا أعلى من طالب علوم دينية جاء لينهل العلوم منه، ولا أعلى من رجل مسنّ جاهل بأُمور دينه جاء ليسمع محاضراته فيتعلم ما يمكنه استيعابه. كان يقول في كلامه: "ليس لديّ جديد لأقوله. نحن نكرر كلام ألف عام مضت. ما قاله الله ورسوله (ص)، وهو كلام يحقق للإنسان السعادة إن عمل به". لكن عندما كنت أنا أتكلم كان يُصغي بانتباه كأنه يتعلم مني شيئاً جديداً، كأنه لا يعلم ما أقوله أو يسمعه لأول مرة في حياته، إلى درجةٍ كنت أظنُّ أنني قد كبرتُ ووصلتُ إلى مقامه. عندما يُجالس الشباب كان يقول: "أنا في الستين من عمري، وسأنزل معكم ثلاثين عاماً، وأنتم أيضا تكلّموا كأنكم أكبر من عمركم ببضع سنوات لنفهم بعضنا".
أما أنا فلم يقل لي ذلك. كان الشيخ ميانجي ينزل بعمره كثيراً إلى درجة أنه كان يكلّم المشاغبَ العزيزَ محمد حسين بلغته. في ذلك الحين لم أكن أعلم أنه قد نهل العلم على يد العلّامة الطباطبائي لسنوات. لم أكن أعلم لماذا يُصر على تقديم الشاي لضيوفه بنفسه إن كنت أنا الضيف أو أحد زملائه من جامعة مدرّسي حوزة قم العلمية. لم أكن أعلم سبب خطبه الموجزة في مسجد عبد اللهي الصغير في تقاطع السوق. لم أكن أفهم سبب بكائه بألم حين رثائه أهل البيت (عليهم السلام) بأبيات زاخرة بالحزن.
كان يردد دائماً: "جميع المشاكل تأتي من التوقعات" عندما تتعلم أن لا تتوقع شيئاً من الآخرين ستعيش أنت والآخرون براحة. مهما حاولتُ أن أكتب عن ذكرياتي معه وتصرفاته، تخطر على بالي ذكريات أحلى معه. مهما تكلمت عنه فلن أُوفِّه حقّه بمقدار قطرة في بحر. لا يمكنني سوى أن أكتفي بجملة واحدة، فأقول: كان المرحوم آية الله الشيخ ميرزا علي أحمدي ميانجي مثالا للاقتداء بالآية الشريفة: "قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ".
كنت أجلس إلى جانبه في ذلك المنزل الصغير في محلة خاكفرج وأتناول العشاء. كان يتكلم ويسمع وينصح نصحاً أبويّاً. لم يكن يفرّق بيني وبين ابنه جعفر. كان لطيفاً إلى درجة أنني في بعض الأحيان كنت أظنّه يفضّلني على ابنه جعفر. كان يستقبلني في أيّ وقت. في بعض الأحيان كنت أُصغي إليه، وفي أُخرى كنت أتكلم وأحيانا كنت أشاغب. لكنه لم يكن ليتركني خارج حنانه الأبوي لي، كجعفر بالضبط. جعفر هو الآخر كان له عقل منير مثل والده. كان يحلّق في الأعلى، كان سامي الفكر إلى درجة أنني في بعض الأحيان لم أكن أفهم كلامه، كنت سعيداً بالأُمور البسيطة ولم أنتبه إلى أنّ جعفراً يبتعد عنّا يوماً بعد يوم. واستعدتُ رشدي عند سماع خبر استشهاده. انتهى كل شيء في ليلة واحدة. ذهب جعفر فخسرت استقراري النفسي. لم أعد أستطيع الجلوس في مكان واحد، من دونه كانت الدنيا غير متّزنة وأصبحتُ أُحسّ دائماً أنني قد فقدتُ شيئاً. كنت أدور وأدور في الشوارع من الصباح إلى المساء، فأفتح عيني لأرى أنني قد وصلتُ إلى خاكفرج، إلى منزل جعفر. المنزل الذي علّمني أهله كل شيء. كان الشيخ يفتح الباب بنفسه، فأرغب بتقبيل يده عندما أرى الابتسامة ترتسم على وجهه الرحيم. كنت أصافحه فأغرق في رائحة عباءته، كانت رائحة جعفر تفوح منها. رائحةُ ضِحْكِه، وصلاته وكلامه. كان جعفر يدلني على الطريق القويم دائماً بمحبةٍ وصبر وحتى عندما نغضب من بعضنا. كأنه كان يعلم أنه سيرحل وإنني سأتخلّف عن القافلة. كان يعلم أنني سأُصبح وحيداً. أشعر أنني سأنفجر بكاءً متمنياً أن يكون معي لحظةً واحدة. كان يمسك بيدي ويدلّني على الطريق الصحيح ولو بالقوة. والآن مرّت 32 عاماً على استشهاده. تكاسلتُ في اليوم الذي أراد منّي أن أسير معه جنباً إلى جنب، وعندما عدتُ إلى رشدي وجدت أنه قد مضى في طريقه. إنه غائب حاضر، موجود معي ولا أراه. كثيراً ما أحسّ بوجوده هو ووالده. في بعض الأحيان ينادونني، وأحيانا يقفون على حدةٍ ويتألمون لما أنا فيه من سوء الحال، في مرات عديدة رزقني الله هدايا ممتازة، وأنا أعلم أنها ببركة دعائهما. في بعض الأحيان تخنقني العَبرة لأنهما ليسا معي. أحياناً أُحس بالتعب من كل هذا الركض من دون الوصول، فأذهب إلى محلة خاكفرج وأجلس أمام منزلهم وأتمنى أن يُفتح الباب ويخرج منه الشيخ مرة أُخرى، واضعاً عباءته على كتفه، لأنهض وألقي التحية وأشعر بالسعادة برؤيته:
- السلام عليكم يا سيد محمد حسين.
كنتُ أشعر بالسعادة دائما وهو يناديني باحترام: أيّها السيد.
يُفتح الباب ويخرج جعفر وأكمام قميصه مطويّة إلى الأعلى وماء الوضوء ينساب على وجهه، فيمرر يده على وجهه ثم يرشّني بيده بقطرات المياه مازحاً. أتمنى أن يأتي ويرشّني بالمياه لعلّي أصحو من الغفلة التي أنا فيها. فأسمع كل ما يقوله. وأنفّذ كل ما يطلب، وأمسك بيده لأذهب معه حيثما ذهب إلى نهاية الطريق، حتى الجنة. أتمنى! أتمنى أن يُفتح هذا الباب مرة أخرى. أتمنى لو كان جعفر والشيخ على قيد الحياة لأعثر على طريق لأتبعهما.
منذ خمس سنوات وأنا أنوي كتابة ذكرياتي، بصورة خاصة بعد أن قال سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله الخامنئي (دام ظله) ما معناه أن حرب المقاتل لا تنتهي حتى يكتب ذكرياته، فازداد عزمي لكتابة ذكرياتي. كنت قد تكلمت سابقاً عن كلّ ما رأيته من شجاعة الرفاق في السلاح ووحدتهم وما تعرّضوا له. وبكتابة ذكرياتي كنت أبحث عن الخفايا، وعن طريقة عبادة رفاقي في السلاح، وعن صداقتهم، وعن حياتهم في ظل الحرب. طريقة الحياة التي يحتاجها الشباب في يومنا هذا.
في أبريل عام 2015 دُعيت لحضور مراسم إزاحة الستار عن كتاب "رسول مولتان "، الكتاب الذي تحدث عن ذكريات الشهيد السيد محمد علي رحيمي. كلما تقدمت في القراءة أحسست أن الكتاب يجذبني أكثر. بإرادة الله ودعاء الشهيد رحيمي، تمت أول جلسة لتسجيل ذكرياتي مع مؤلف كتاب "رسول مولتان" في منتصف شهر شعبان . ومنذ ذلك اليوم فقد استغرقت مراحل العمل من الكتابة، والتصحيح، والتدقيق اللغوي وتقديم الوثائق قرابة ثلاث سنوات، وتمّ عرض النسخة النهائية في 31 مارس عام 2018 والذي صادف الثالث عشر من شهر رجب . سأعتبر أنّ بداية العمل في أيام عيد ونهايته في أيام عيد فألاً حسناً، وأشكر جميع الأعزاء الذين ساعدوني في نقل هذه الأمانة التي كانت تثقل كاهلي، بصورة خاصة اللواء حاج أحمد فتوحي لتقديمه مساعدة كبيرة في قراءة النصوص العسكرية والعمليات الحربية وتدقيقها إذ كان من القادة العسكريين أيام الحرب، وكذلك مؤسسة "حماسة هفده" التي ساهمت في رفدنا بصور رفاق السلاح، الذين أُحسّ أنهم ما زالوا يقفون إلى جانبي ويُقوّمون زلّاتي ويدلّوني إلى الطريق الصحيح. كذلك أشكر دار الشهيد كاظمي للنشر، حيث تابعوا العمل بدقة واهتمام حتى نشر الكتاب. هذا الكتاب يعتبر جزءاً بسيطاً من جهاد رفاقي في السلاح وتلبية نداء الإمام الخميني (رحمه الله) نائب إمام الزمان (عجل الله فرجه الشريف) وأتمنى أن ينال الكتاب رضا مولانا إمام الزمان (عج) وأن يشفع لي رفاقي الشهداء يوم الحسرة. الرفاق الذين رأيتهم مرة أُخرى خلال روايتي للأحداث وقاتلتُ بين صفوفهم، جلستُ معهم في الكمائن والسواتر الترابية، فتعرضتُ للإصابات، صلّيتُ، ضحكتُ، مزحتُ. قبّلتهُم ولفّني عطرُهم، ومرة أُخرى وقفت متفرجاً وهم يلتحقون بقافلة الشهداء، فأصبحت وحيداً مرة أخرى. إنّ روحي غارقة في الوحدة والشوق. أتمنى الوصول إلى السماء وأتمنى أن يكون هذا الكتاب جسراً يقودني للوصول الى أصدقائي الشهداء. الجسر الذي يبحث عنه كل الباحثين عن الحقيقة، جسر نحو السماء.
محمد حسين حسيني يكتا
27 رجب 1439
14 أبريل 2018
عاهدتُ
في ليلةٍ كنتُ في الشلامجة فعاهدتُ أشخاصاً ما زالت الأرضُ رطبةً بدمائهم.
عاهدتُ مَن كان يفصلني عنهم حجاب صغير وخفيف.
مَن خُلقوا من تراب ووصلوا إلى لقاء ربّ الأرباب.
وفيتُ بعهدي حتى نهاية هذا الكتاب الذي أتمنىّ أن يكون ورقة ناصعة في كتاب أعمالي.
أسألكم الدعاء بحسن العاقبة
زينب عرفانيان/ أبريل 2018
خوزستان، شلامجه، نهر خيّن




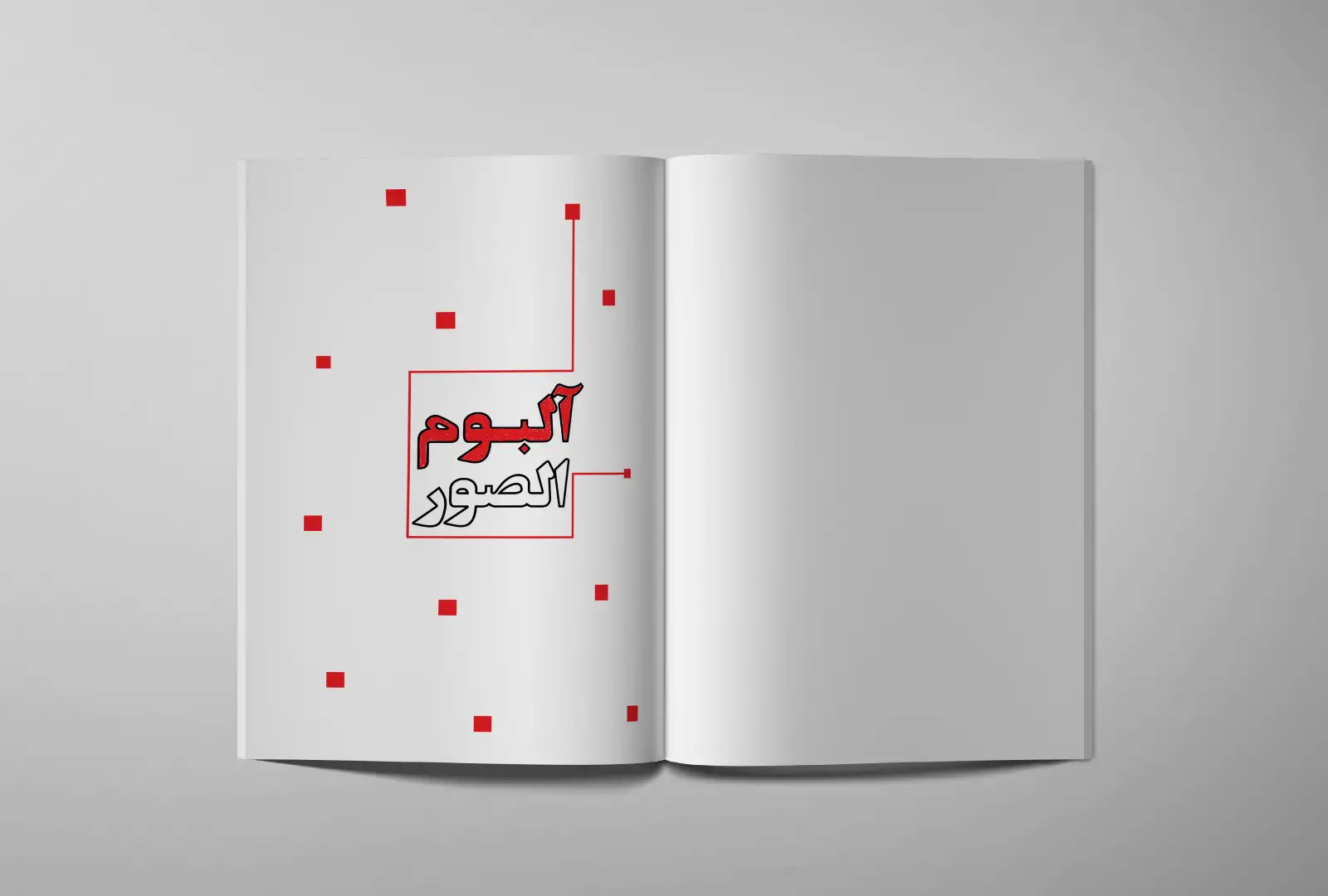











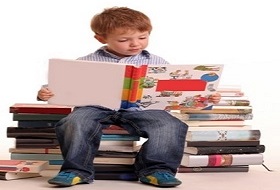













تعليقات الزوار